لن أكشف هنا الأسباب السياسية الكامنة -حسب رأيي- وراء انتخاب رئيس الجمهورية بالاقتراع العام غير المباشر. فالأمر يتعلق بموضوع حسّاس لا ينبغي التطرّق له على أعمدة الجرائد، وإنما يُثار هذا النوع من الأفكار في العادة عبر مشافهة المعني وجها لوجه.
بيْدَ أني أظل على قناعة، من منظور مستقبلي، بأن الشرط الضروري للحفاظ على السكينة والسلم الأهلي والمدني والاستقرار السياسي، بل وديمومة الدولة نفسها واستمرار مؤسساتها، يكْمن في إقامة جمهورية جديدة تتلاءم مع التحوّلات التي يشهدها العالم. فما المقصود بذلك؟
تقتضي إقامة الجمهورية الثالثة أن يكون الرئيس مستقبلا منتخبا من لدن هيئة انتخابية تتألف من كبار الناخبين كما هو الحال الآن في الولايات المتحدة الأمريكية وكما كان الشأن قديما في فرنسا عند بداية الجمهورية الخامسة.
فباعتماد هذا الأسلوب الجديد سيستمر انتخاب الرئيس بالاقتراع العام لكن بواسطة اقتراع عام غير مباشر. ذلك أنه سيصوت عليه منتخبون اختارهم مجموع المواطنين. وتتكوّن هيئة الناخبين الكبار من البرلمانيين (نوابا وشيوخا)، ومن 219 عمدة، ومن بضعة آلاف من المستشارين البلديين والجهويين.
ويساعد الرئيسَ نائبُ رئيس يختاره هو نفسه ويشكل معه ثنائيا يتم انتخابه في الاقتراع الرئاسي. ويُشعر هذا الثنائي الذي يترأس الجهاز التنفيذي بتشابه مع ما يجري في الولايات المتحدة الأمريكية. غير أن الفرق هنا يتمثل في عدم وجود ولايات فيدرالية ولا حتى دولة اتحادية. ففي الحالة الموريتانية المرتقبة ستكون الولايات ذات استقلال ذاتي في إطار دولة موحّدة. ومع ذلك، يمكن القول إن هذا النظام الدستوري يشكل صيغة من النظام الأمريكي بملامح مخصوصة.
السلطة وكَوَاِبحُها
في الصيغة التي نقترحها سيكون الرئيس منتخبا لعُهْدة مدتها خمس سنوات قابلة للتجديد مرة واحدة. ولن يكون لنائب الرئيس سلطات خاصة، بل يقتصر دوره على الحلول محل الرئيس عند شغور المنصب.
وبمقدور الرئيس الذي يمسك حقيقة بمقاليد السلطة التنفيذية أن يُشرك نائبه في تسيير الشؤون الجارية أو يتركه بمعزل عنها، إلا أن نائب الرئيس بحكم انتخابه ضمن الثنائي الرئاسي لا يمكن تجريده من وظائفه.
وفي الدستور الجديد سيتم إلغاء منصب الوزير الأول، وكذا الشأن بالنسبة للمسؤولية السياسية للحكومة (أو على الأصح الديوان الوزاري). فالوزراء سيكونون مجرد أعوان للرئيس. ولن يتجاوز عددهم الخمسة عشر. وسيعتمدون في عملهم على وكالات متخصصة. وفي المقابل، سيتم كذلك إلغاء حق الرئيس في حل البرلمان. كما لن يكون باستطاعته حل المجلس الدستوري الذي سيُحال دوره في التحكيم بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية إلى المحكمة العليا.
وفي التصميم المقترح، سيكون لدينا ثلاث سلط مستقلة كل منها عن الأخرى. وسيكون لكل من هذه السلط مجالها الخاص بها والذي لا يتداخل مع مجال سلطة أخرى.
ويتولى البرلمان (الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ) التصويت على القوانين ويكون له اليد الطُّولَى في إعداد الميزانية. وبتحكّمه في العصب المالي سيُمارس البرلمان التأثير المطلوب في رسم السياسة الداخلية والخارجية.
وسيكون بمقدور البرلمان أن يعطّل بعض المبادرات التي يتخذها رئيس الدولة. وبفضل صلاحياته الدستورية، سيُتاح له تشكيل لجان تحقيق. وعلاوة على ذلك، ستكون موافقة مجلس الشيوخ لازمة لإقرار التعيينات في المناصب العليا للدولة كالولاة، والسفراء، إلخ.
السلطة القضائية
من المعلوم أن السلطة القضائية تشكل حجر الزاوية والأساس الذي يقوم عليه أي نظام سياسي جدير بهذا الاسم. لكن، مع الأسف، ما تزال السلطة القضائية في موريتانيا، على غرار نظيراتها من الدول النامية، خاضعة للسلطة التنفيذية. ذلك أن المجلس الأعلى للقضاء بتشكيلتيْه (القضاء الجالس والنيابة العامة) يترأسه رئيس الجمهورية.
وتبقى الاستقلالية التي يتمتع بها هذا المجلس نظرية ما دامت وظائف القضاة تسيّرها الأجهزة التنفيذية. ولكي يستعيد القضاء أُبّهته وهيبته وفعاليته واستقلاله –وهي الأمور التي تكرّس حياده– ينبغي أن يقطع الحبل السُّرّيّ الذي يربطه عمليا بالسلطة التنفيذية. وهذا التغيير مطلب ما فتئ ينادي به المواطنون، والفاعلون الاقتصاديون الوطنيون، وبالأحرى المستثمرون الأجانب.
وكثير من المستثمرين، وبالأخص العرب والغربيين، غالبا ما يسْتَنْكِفون عن الاستثمار في موريتانيا لأسباب لها صلة بالإشكالات القضائية تحديدا. فاستقلال القضاء شرط لا غنى عنه في أية نهضة اقتصادية أو اجتماعية. وهذا ما يستدعي بإلحاح القيام بإصلاح قضائي جذري.
وستتألف المحكمة العليا التي سيُرفع مقامها إلى مصافّ المؤسسات الدستورية من تسعة قضاة يعيّنهم رئيس الجمهورية بتأكيد لهذا التعيين من قِبَل مجلس الشيوخ لمأمورية مدتها تسع سنوات.
الوضع الجنائي لرئيس الجمهورية
طرح مفهوم "الخيانة العظمى" (المادة 93) المقتبس من الدستور الفرنسي العديدَ من صعوبات التأويل. ووقعت مواجهة بين فقهاء القانون مستدلّين بحجج متناقضة. وبالفعل، تتّسم هذه الصياغة التعبيرية بالغموض وهي حمّالة أوجه. والحال أن الوضع الجنائي لرئيس الدولة يجب أن يكون واضح المعالم.
في فرنسا، تم التنبّه مع مرور الزمن إلى هذا الالتباس وما قد ينجم عنه من عواقب. لذا عمد المشرّع الفرنسي، عبر قانون دستوري (23 فبراير 2007)، إلى توضيح الوضع الجنائي لرئيس الجمهورية. فجرى حذف جريمة الخيانة العظمى وتعويضها بمسطرة إجرائية للعزل (المادة 68) في حالة "إخلال رئيس الدولة بواجباته على نحو لا يتناسب بجلاء مع ممارسته لولايته".
"ومن بين الظروف المستدعية للشروع في هذه المسطرة، يوجد:
• القتل أو أي جريمة خطيرة أخرى؛
• السلوك المنافي لشرف الوظيفة؛
• الاستخدام المفرط للسلطات الرئاسية بما يؤدّي إلى تعطيل المؤسسات".
وفي فرنسا، يمكن لكل من الجمعية العامة أو مجلس السيوخ أن يتخذ المبادرة بإطلاق مسطرة العزل.
"والبرلمان المجتمِع برمّته على شكل محكمة عليا هو الذي يمكنه أن يعلن عزل الرئيس بتصويت غالبية لا تقل عن الثلثين. ويترأس هذه المحكمة العليا رئيسُ الجمعية الوطنية. وهي تعمل عن طريق بطاقات تصويت سرية. ولا تبتّ هذه المحكمة العليا في تجريم الرئيس وإنما في شرعيته السياسية لمواصلته لمهامه. ويكون لقرار عزل الرئيس مفعول فوري".
وللخروج من اللبس والغموض الذي يكتنف المادة 93 من دستورنا الحالي، يمكننا الاقتباس من الحالة الفرنسية المذكورة آنفا.
التغلب على الجمود الراهن
قد يحتجّ المناصرون للوضع القائم بأن النظام المقترح يمكن أن يؤدّي إلى عرقلة المؤسسات في بلد لم تترسّخ فيه الديمقراطية بعدُ. غير أننا لو رجعنا إلى الماضي لوجدنا أن موريتانيا تكيّفت مع نظام الحزب الواحد على الرغم من وجود نزعات قومية على خلفية تنوّع عرقي وتجاذبات قبلية وجهوية وفئوية.
وفيما بعد، فتح دستور 1991 الطريق إلى تعددية الأحزاب السياسية التي نادرا ما تكون لها قواعد شعبية. وهنا أيضا، تكيّف الموريتانيون مع التجربة السياسية الجديدة.
فالديمقراطية مسار طويل من الدُّرْبَة والمِراس. ولا تخلو بداياتها من تعثّر وانتكاسات. والأهم هو رسم هدف والمواظبة على درْب المسير، مثل البذرة التي تُزرع ويتم تعهّدها حتى تنمو وتثمر.
على أننا يجب ألا ننخدع بالمظاهر، فالإصلاحات الشكلية وغيرها من الإجراءات المبتذلة لا يمكنها أن تغيّر مصير بلد.. وقد قال ألبير أينشتاين: "لا يمكننا حل المشاكل بالوسائل التي تسبّبت في حدوث هذه المشاكل".
ومتى تخلّصنا من رواسب الماضي، أمكننا القول إن المناخ السياسي مُواتٍ للشروع في هذه التجربة الديمقراطية الجديدة. فالعقليات في موريتانيا قد تطوّرت كثيرا وأرغمت إكراهات الحياة اليومية الناسَ على الوعي بأن مستقبلهم، على الصعد السياسية والاقتصادية والاجتماعية، مرتبط بالدولة. وقد تغيّرت المسلكيات القديمة بفضل انتشار وسائل الاتصال والإعلام من هواتف، وقنوات تلفزية، وشبكات تواصل اجتماعي، فضلا عن ميْل الموريتانيين بطبعهم إلى الاهتمام بالسياسة. ويعني كل ذلك أن من غير المقبول أن نبقى جامدين في ظل مؤسسات عتيقة لا تواكب تطورات العصر وتتخذها بعض النخب العسكرية والمدنية مطية لاحتكار السلطة والثروة لمصالحهم الذاتية.
لقد آن الأوان لبعث الحياة من جديد في سياستنا الوطنية. وإن الأرضية لملائمة في الوقت الحالي لخوض غمار هذه التجربة السياسية المنقذة من الركود. وقد يُتوّج المسار بإرساء ثنائية قطبية في الحياة السياسية. وهو ما سيؤول في النهاية إلى تناوب على دفة الحكم.
ولهذا الغرض، يلزم حصر عدد الأحزاب دستوريا في حدود العشرة على أساس الاشتراك في الحساسية والمشروع المجتمعي. وسيُفضي تجميع الأحزاب في كتلتيْن أو ثلاث بحسب انتماءاتهم الأيديولوجية، إلى نشوء تحالفات سواء على مستوى البرلمان أو على مستوى الولايات ذات الاستقلال الذاتي.
قد يبدو هذا التغيير الجذري لأول وهلة بالغ التعقيد وصعب التحقيق. لكن ما دامت المصلحة الوطنية تتطلبه فلا مناص منه ولا مندوحة عنه. وقد قال سينيك: "إننا لا نجرؤ على القيام بالأعمال لأنها صعبة وإنما هي صعبة لأننا لا نجرؤ على القيام بها".
وقبل أن نختم هذا المقال، يجدر أن نقدم ملاحظة مفادها أن ما عرضناه من أفكار في الأسطر السابقة ليس تِرْياقا ولا وصفة سحرية، وإنما نستهدف منه إثارة النقاش حول المستقبل السياسي والمؤسسي للبلاد. وبالإمكان إخضاعه للتعديل والتمحيص والتكملة.
وأخيرا، من الثابت والمسلّم به أن قيام جمهورية ثالثة في موريتانيا سيخلد على مرّ التاريخ اسم رئيسيْن: أحدهما لأنه حصل على استقلال البلاد في سياق وظروف صعبة، والآخر لأنه عمل على إرساء ديمقراطية حقيقية.

.gif)

.gif)
.png)
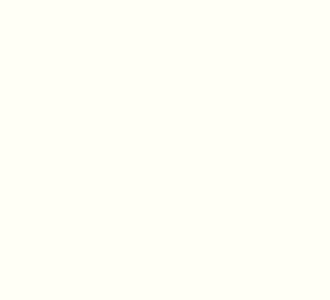











.png)
.png)