في الوقت الذي تواجه فيه موريتانيا تحديات هيكلية عميقة، تتطلب بلورة رؤية استراتيجية واضحة وحشد الجهود حول برامج تنموية طموحة، يبدو أن الجدل السياسي بدأ ينزلق نحو فرضية التمديد لرئيس الجمهورية الحالي، رغم القيود الدستورية التي تحدُّ من عدد الولايات الرئاسية. وهي مسألة سَبَق أن أُثيرت في عهد سلف الرئيس الحالي، كما طُرحت في العديد من دول المنطقة وخارجها، غير أنها اليوم مرشحة لأن تستحوذ على اهتمام الفاعلين السياسيين والرأي العام، على حساب القضايا التنموية الجوهرية.
وتُغذّي هذه الفرضية موجة متنامية من الإشاعات، مدفوعة بتكاثر التصريحات الصادرة عن فاعلين سعيا وراء الترقي داخل دوائر النفوذ. ويبدو أن سباقا محموما انطلق للدعوة لولاية ثالثة، ولو تطلب ذلك الدوس على كل ما حققه البلد من مكاسب في سبيل إرساء أسس تداول سلمي للسلطة. وتهدف هذه المواقف إلى تسويغ فكرة مراجعة الدستور، عبر التلميح والإيحاء، وأحيانا التصريح المعلن، للسماح للرئيس الحالي بالترشح لولاية ثالثة. ومن المرجح أن تتزايد مثل هذه الدعوات كلما اقتربت نهاية الولاية الراهنة، في إطار تنافس محموم للتقرب من السلطة وما يترتب عن ذلك من امتيازات. وفي هذا السياق، لا يتردد بعض الفاعلين في التضحية بالمكاسب الدستورية المحدودة التي حققها البلد بعد تجربة مريرة، متبنين الشعار المشبوه: «لينهدم البئر ما دام الحمار قد ارتوى». ولا يكترث هؤلاء بالتراجع الديمقراطي الذي سيحصل ولا بنقض العهود ولا بالحنث بالقسم الدستوري، ما دام ذلك يتيح لهم استقطاب رضى السلطة ونيل مكافآتها.
ويزداد تمرير مثل هذا التوجه سهولة في ظل المستوى المحدود للوعي المدني بين السكان، إذ يمكن تعبئة ما يُعرف بـ«موريتانيا الأعماق»، بما تضمه من شبكات أعيان ووجهاء ونخب انتهازية، دائمة السعي إلى كسب ريع ومنافع السلطة. وعندئذ، سيتكفّل ما تزخر به البلاد من قانونيين وخبراء وبفضل ما يملكونه من براعة، بالبحث عن الصيغة «السحرية» لإخراج سيناريو المراجعة الدستورية، وإضفاء الشرعية عليها. ولا يزال الكثيرون يتذكرون مبادرة «بطاقة التصويت الحيادي» الفاشلة سنة 2007، التي كان يُراد منها تمهيد الطريق للتمديد لرئيس المرحلة الانتقالية آنذاك.
تقييد عدد الولايات الرئاسية صمام أمان في وجه الانحراف السلطوي
قد يرى البعض أن الحد من عدد الولايات الرئاسية الذي أقره الدستور عقب مراجعته سنة 2006، ليس مقدسا في حد ذاته، وأنه يمكن رفعه بالآلية نفسها التي وضع بها، بما في ذلك عن طريق الاستفتاء الدستوري، استنادا إلى مبدأ تماثل الإجراءات القانونية. فلا يمكن إنكار قابلية الدستور للتعديل، إذ إن ما أُنشئ بنص يمكن تعديله بنص مماثل، باعتبار الدستور نصا حيا يُفترض أن يواكب تطور المجتمع. غير أن جوهر الإشكال لا يكمن هنا، إذ إن المسألة ليست قانونية بقدر ما هي سياسية وأخلاقية بامتياز.
فتحديد عدد الولايات الرئاسية، الذي أُقر سنة 2006 عقب مرحلة طويلة من الاستبداد والتي لا يزال الموريتانيون يدفعون ثمنها، لم يكن مجرد إجراء تقني كغيره من الإجراءات، بل شكّل صمام أمان لمواجهة الانزلاق نحو الاستبداد. وقد جاء هذا القيد الدستوري ثمرة توافق وطني واسع، شاركت فيه النخب السياسية وغالبية الرأي العام، باعتباره قطيعة مع أنماط تداول السلطة الموروثة عن الماضي. وكان هذا التوافق بمثابة التزام أخلاقي جماعي لإرساء أسس حوكمة رشيدة.
وعليه، فإن أي محاولة للعبث بهذا القيد الدستوري، مهما كانت صيغتها وآلياتها ومبرراتها، من شأنها أن تقوّض الأسس الهشة لبناء الدولة، وأن تمس بشرعية السلطة ذاتها. كما ستؤدي إلى تقويض توافق وطني تَحقق بصعوبة، وإلى التراجع عن المكاسب المحدودة في مجال الحوكمة. فضلا عن ذلك، فإن هذا المسار سيُضعف الاستقرار النسبي الذي يمثل اليوم أهم مكسب للبلاد في محيط إقليمي ودولي يلفه عدم الاستقرار، وقد يعيد البلاد إلى دوامة جديدة من عدم الاستقرار ويعيق مساره التنموي.
وإلى جانب ذلك، ستتعرض صورة موريتانيا على الصعيد الدولي لضرر بالغ. إذ لا يخفى أن التنمية وجاذبية الدول ترتبطان، إلى حد كبير، بصورتها في الخارج. ويكتسي هذا الأمر أهمية خاصة في ضوء الجهود المبذولة لاستقطاب الاستثمارات الأجنبية، الضرورية لاستغلال الموارد الوطنية وتنويع الاقتصاد. ومن شأن الإقدام على مثل هذه الخطوة أن يعزز الانطباع بدولة عاجزة عن احترام قواعدها الذاتية، أي «جمهورية موز» أخرى لا تتردد في التضحية بدستورها والدوس على ضوابطها المؤسسية حسب أهواء حكامها وحاشيتهم من المتحمسين.
إن تحديد عدد الولايات الرئاسية يمثل التزاما ينبغي احترامه بدقة إذا كنا نريد بناء مؤسسات راسخة. فالأمم لا تُبنى إلا عبر نظم وآليات مستدامة. فالدول الأكثر استقرارا وتقدما هي تلك التي نجحت في إرساء قواعد ثابتة تسمو على النخب الحاكمة. أما المساس بهذه المعادلة، فيفتح الباب أمام الانحرافات ويُضعف مجمل البنيان المؤسسي. وينبغي تقديم استقرار الدولة على الحسابات الضيقة ومزاج الحكام، إذ لا يمكن، مع نهاية كل ولاية، إعادة فتح هذا الملف دون المساس بمبدأ دولة القانون وحصانة الدستور.
ومن المهم التذكير، في هذا السياق، بأن هذه الدعوات لتجاوز الدستور لم تُعتمد علنا من قبل رئيس الجمهورية أو دائرته المقربة. غير أن مواقف بعض كبار المسؤولين، التي لم تُقابل بنفي أو توبيخ، كفيلة بإثارة الشكوك. ويزداد هذا التناقض حدة نظرا لتزامن هذه الدعوات مع قرب إطلاق حوار وطني يُفترض أن يعيد بناء الثقة بين الفاعلين، ويعزز التوافق الوطني، ويعالج الملفات العالقة، ويحسن من نظم الحوكمة. إذ إن إدراج هذه المسألة ضمن جدول أعمال الحوار المرتقب من شأنه تقويض المسار من أساسه وإجهاض مبادرة كانت تعلق عليها الآمال. كما أن قوى المعارضة، بما فيها الأكثر مرونة، ستقاطع المسار، مما سيعزز مواقف التيارات المشككة في جدوائيته. فضلا عن أن مثل هذه الخطوة سيشكل غطاء سياسيا صريحا، يصعب معه إقناع الرأي العام بأن رئيس الدولة بريء من هذه الفكرة، لا سيما أنه سبق أن دعم، في الماضي، مبادرة مماثلة كانت ترمي إلى التمديد لسلفه، قبل أن يتم إحباطها، لحسن الحظ.
ويكشف هذا الجدل عن ظاهرة مقلقة في الحياة السياسية الوطنية، تتمثل في ميل النخب إلى تصوير الحاكم قائدا مُخلّصا، أحيانا رغما عنه. وتعكس هذه الشخصنة المفرطة ضعف الثقة في المؤسسات. وقد كانت هذه الوضعية قائمة في الماضي ولا تزال اليوم، رغم التحولات الاجتماعية البنيوية الجارية. ولا بد من التأكيد أنه لا وجود لـ«منقذ» في السياسة، كما أن البلد ليس بحاجة إلى قائد ملهم وإنما لترسيخ مؤسساته ونظمه الدستورية وتهيئة الأجواء لتوافق وطني مستدام.
آمال خائبة
وبالنظر إلى الحقبة الماضية، يتضح أن الآمال التي عُلقت على رئيس الدولة الحالي كانت مبالغا فيها. إذ لم يكن في مساره أو في سياق وصوله إلى السلطة ما يبرر موضوعيا أن نتوقع قطيعة مع ممارسات الماضي. فقد جاء الرجل إلى الحكم من رحم نظام وُصف بالفاسد، كما كان طرفا فاعلا في الانقلاب الذي أطاح برئيس منتخب، بالإضافة إلى التزامه الصمت إزاء انحرافات سلفه، بما يجعله امتدادا لنهج الحكم المضطرب يدوم منذ أربعة عقود. كما أن الكثير من قراراته وطبيعة محيطه تعكس هذه الاستمرارية، من خلال إعادة تدوير نخب اتهمت بالفساد وسوء التسيير.
فهل يمثل الرئيس الحالي الزعيم الإصلاحي الذي يتطلع اليه البلد؟ وهل قام بإطلاق الإصلاحات الهيكلية المطلوبة، أو نفذ برامج تَحوُّل بحجم التحديات الراهنة؟ وهل تتناسب المنجزات المحققة منذ توليه زمام الأمور مع حجم الموارد التي أُنفقت (نحو ألف مليار أوقية جديدة، أي ما يعادل 25 مليار دولار، خلال السنوات السبع الأخيرة)؟ سيكون قطعا من غير المنصف الحكم عليه على أساس مشروع إصلاحي لم يدّعه ولم يلتزم به. فلا هو تعهد يوما بالقطيعة مع الماضي ولا هو التزم بمشروع تقدمي، بل أعلن صراحة وفي أكثر من مناسبة رغبته الاستمرار في نهج سلفه، وهو وعد يبدو أنه وفى به حتى الآن، مع تغيير في الأسلوب. كما أن اعتماده لمنطق التوافق الهش، وتردده في إحداث أي قطيعة، ولو كانت ضرورية، وقربه من نخب تحوم حولها شبهات فساد، وتلكؤه في اتخاذ إجراءات صارمة في حقها، خشية إثارة سخطها، كلها عوامل أسهمت في تفشي الفساد واستمرار الإفلات من العقاب.
وقد بلغت اليوم خيبة الأمل الشعبية اتجاه هذا النمط من الحكم مستوى غير مسبوق. ومع ذلك، لم تعرف الموارد العمومية في أي وقت مضى الطفرة الحالية، مدفوعة بزيادة الضغط الضريبي وبداية تنويع الاقتصاد، وإن ظل دون الإمكانات المتاحة. غير أن التطلعات لا تزال قائمة، بل تزداد إلحاحا، في وقت تشعر فيه الفئات الأكثر هشاشة وبحق بأنها مقصية، فيما تستأثر أقلية من رجال الأعمال المشبوهين والمرتبطين بالنخب الحاكمة بحصة الأسد من عائدات النمو. ويتفاقم هذا الوضع بفعل غياب رؤية استراتيجية واضحة وضعف الإرادة السياسية، في حين تتطلب التحديات الكبرى، مثل الفساد والفقر والإقصاء، قرارات حازمة وقطيعة جذرية مع بعض الممارسات السائدة.
وخلاصة القول، إن الجدل حول الولاية الثالثة يكشف سلم أولويات مقلق، إذ يبدو أن هاجس بقاء النظام يتقدم على الاستجابة لتطلعات المواطنين واحترام النظم الدستورية. غير أن السعي إلى البقاء في السلطة عبر حيل قانونية، وتعبئة «الدولة العميقة» وشبكات الزبونية، لا يشكل خيارا مستداما، بل هو وصفة بالية، في وقت يحتج فيه الشباب، حتى على مقربة من حدودنا، مطالبا بتحسين الظروف المعيشية، وخدمات عمومية أفضل، وعدالة اجتماعية أشمل. فبلادنا ليست بمنأى عن العالم، وما يجري حوله ينبغي أن يدق ناقوس الخطر لدى قيادته، قبل وقوع العاصفة. فلا سبيل للنجاة سوى عبر التزام حازم بمحاربة الفساد، وإطلاق إصلاحات طموحة، وتقديم حلول ملموسة لمعالجة الإحباط الشعبي، بما يخفف التوترات ويحول دون انفجار الاحتجاجات الكامنة.

.gif)


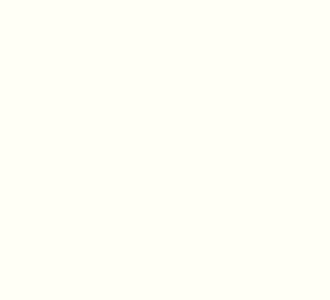













.png)